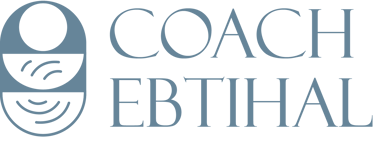للحياة معنى
9/11/2023
في خواتم القرن التاسع عشر شهد علم النفس نقلة كبيرة على يد سيغموند فرويد، ومن مطلع القرن العشرين إلى منتصفه طغت على الساحة نظريتان إحداهما التحليل النفسي التي تصدرها فرويد، والأخرى علم السلوك الذي كان من رواده واتسون وسكينير.
أبرز ما كان يشغل العلماء آنذاك هو الطبيعة الإنسانية، ماهية الشخصية الإنسانية، ونموها وتشكلها وما يؤثر فيها، ومن أهم القضايا التي كانت تشغل الباحثين آنذاك، سبر أغوار الدوافع التي تحرك سلوكيات الإنسان وتؤثر في فكره وتصرفاته، وتنبئ بما يقدم عليه.
كانت الدارونية هي الثقافة السائدة في المجمعات العلمية في مطلع القرن العشرين، وبالتالي كان ينظر للمولود على أنه في طور متوسط بين القرد والإنسان البالغ، فالرضيع الإنسان يشترك مع الحيوانات في الدوافع البدائية، أي غريزتي الجنس والجوع.
ومن هذا المنطلق، توصل فرويد (1856- 1939)، إلى أن المحركات البيولوجية هي الدوافع الأساسية للإنسان، وحددها في غرزيتين: غريزة الجنس التي تحفظ التكاثر، وغريزة حفظ الحياة: كالجوع والألم، موضحًا أن كلتا الغريزتين تحفظان البقاء الإنساني، ثم ألحق بهما إثر لحرب العالمية الأولى غريزة هدم الذات.
تكلم فرويد في تفاصيل تلك التأثيرات الباطنة في النفس الإنسانية، والصراع القائم بين درجات النفس الثلاث من اللاوعي إلى الوعي، وتأثير ذلك على تصرفات الإنسان وما يعتريه من مشاكل نفسية، كما ربط تشكل السلوك الإنساني بخمس مراحل في الطفولة سميت بالمراحل السيكوجنسية، حيث يتعرض الإنسان لعقد نفسية مرتبطة بعوامل غرائزية جنسية تختص بكل مرحلة.
والذي يعنينا هنا أن مدرسة التحليل النفسي حصرت الدوافع التي تؤثر في سلوكيات الإنسان بالجانب الغرائزي الحيواني.
أما من رأى من العلماء تأثير البيئة المحيطة على الإنسان من المنتمين إلى نظرية التعلم، فقد نفوا أن يكون سلوك الإنسان منقادًا لما يعتمل في باطنه، فجاء واتسون (1878- 1958) واتهم فرويد وأتباعه بالشطط عن المنهج العلمي، وربَط واتسون الدوافع بمؤثرات خارجية، حيث يكتسب الإنسان السلوكيات من خلال تكرار الربط بين المحفز والاستجابة، فالسلوك مكتسب بالتعلم والتدرب الشرطي، وسمي ذلك بالتربية الكلاسيكية (أو التكيف الكلاسيكي)، وقد توصل لذلك بعد تأثره بتجربة باﭬلوﭪ الشهيرة على الكلاب، فقام بتطبيقات مشابهة على الحيوانات و البشر، فكانت بداية نظرية علم السلوك.
ثم تبعه سكينير (1904- 1990)، الذي رأى أن تفسير واتسون للسلوك من خلال محفز يعقبه استجابة، وإن كان صحيحًا إلا أنه تسطيح للواقع، وأن التفسير الأدق يكمن في العواقب المرتبطة بالاستجابة، فذاك هو المحك، وسمى تلك العملية التعليمية بالتربية التشغيلية (أو التكيف التشغيلي)، حيث يتعزز السلوك من خلال عواقب إيجابية أو سلبية، فينتج إما الإقبال على التصرف أو انصراف عنه، تبعًا للعاقبة، فخلص سكينير إلى الحتمية، وأن سلوكيات الإنسان يمكن تحديدها وبرمجتها، كالآلة تماما، نافيًا الغايات والمقاصد بل وحرية الإرادة.
ومما يُحسب لهذه المدرسة من اسهامات هو تركيزهم على المنهج العلمي التجريبي المنضبط، وأخذت عليهم المغالاة في ذلك إلى حد عدم اعتبار ما لا يدخل في دائرة الملاحظة الحسية، كالمشاعر والأفكار.
شطح رواد تلك النظريتين وتطرفوا في طرحهم المتعلق بالطبيعة البشرية، متأثرين بالفلسفات السائدة، وبمجريات العصر من حروب وحشية أبرزت بشاعة ما يمكن أن ينحدر إليه الإنسان، ونهضة مادية بحتة تمثلت في الثورة الصناعية غير المسبوقة في تاريخ البشرية، فانطوى طرحهم على حط قدر الإنسان إلى مرتبة الحيوان حينًا، وتشييئه حينًا آخر.
خلال تلك الفترة أيضا ظهرت العديد من النظريات العلمية النفسية التي نأت عن تشييء الإنسان، أو حصر مقاصده على الغرائز الحيوانية.
إحدى أبرز تلك النظريات كانت نظرية العلاج بالمعنى Logotherapy التي وضعها فيكتور فرانكل (1905-1997)، وحظت برواج واسع حتى إن كتابه “بحث الإنسان عن معنى” أعيدت طباعته أكثر من مئة مرة بالانجليزية، إضافة إلى ترجمة الكتاب إلى بضع وعشرين لغة، وبيع ملايين النسخ.
يرفض فرانكل حط الإنسان إلى مرتبة الحيوان أو الأشياء، ويرى أنه بالرغم من صحة بعض ما ورد في علم التحليل النفسي وعلم السلوك من وجود غرائز تعتمل في نفس الإنسان، وتجاوب الإنسان مع المحفزات، وتكيفه مع الظروف، إلا أن الإنسان أسمى وأرقى من أن يكون أسيرًا لغريزة، أو أن تكون أفعاله شرطية تخضع لقوانين آلية، وبالتالي فلا ينبغي التوقف عند تلك الدوافع والغرائز والاكتفاء بها، بل ينبغي النظر إلى ما هو أبعد من ذلك، والوصول إلى الحرية والكرامة الإنسانية.
ويضرب فرانكل مثلًا لما ذهب إليه أولئك بقصة طريفة، فيقول ادعى رجل على جارٍ له عنده قطة، فاتهم قطة جاره بأنها إلتهمت رطلين من زبدته، فأنكر صاحب القطة، وتحاكما إلى الحاخام، فطلب الحاخام احضار القطة وميزان، ثم وزن القطة فإذا بها تزن رطلين بالتمام، فقال الحاخام: هاقد وجدنا الزبدة، فأين القطة؟
وبالمثل يقول فرانكل حصرتم أفعال الإنسان في المحفزات والغرائز الحيوانية، فأين الإنسان؟
وفي نظرية العلاج بالمعنى يقدم فرانكل ثلاثة مبادىء رئيسة:
إحداها إرادة المعنى، في مقابل إرادة المتعة عند فرويد، إذ يرى فرانكل أن حياة الإنسان بكل تقلباتها وأطوراها لا تخلو عن معنى تنطوي عليه، حتى ما تفرضه الأقدار من معاناة وألم، في طياته معنى.
ومعنى الحياة هو المبدأ الثاني.
والمبدأ الثالث هو حرية الإرادة، فهي كالسلسلة المترابطة.
ومبدأ حرية الإرادة ينقض فكرة الحتمية التي ذهب إليها رواد نظرية السلوك، فمع أن فرانكل يقول بتأثير المحفزات والمعززات ، إلا أنها ليست قاهرة للإنسان ولا هو منقاد لها، فهو حر الإرادة في كل أحواله، بل إن الإنسان وإن حبس وقيد ووضعت الأغلال في يديه، يستطيع أن يحتفظ بحرية روحه وكرامته الإنسانية، فظاهره مقيد وباطنه ينعم بالحرية، ويظهر ذلك من خلال تمسكه بالقيم والأخلاق النبيلة في أحلك الظروف.
فيكتور فرانكل، وهو طبيب نفس وأعصاب من فيينا، لا يتكلم من موقع تنظيري بحت، ولا يقدم تصورات تجريدية منفصلة عن الواقع، فقد خبر الألم وذاق مرارة الهوان، إذ أنه حبس وعذب أبان الحرب العالمية الثانية في معتقلات النازية لعدة سنوات، وفقد في تلك المعتقلات أمه وأباه وزوجته وأخاه، إلا أن نظريته لم تكن وليدة تلك المعسكرات أيضا، بل إنه حين اعتقل، كان قد أتم مسودة كتاب له عن النظرية، فتأخر ظهور نظريته إلى ما بعد انتهاء الحرب وخروجه من المعتقل، (نشر كتابه لاحقًا بالانجليزية في الولايات المتحدة بعنوان الطبيب والروح)، فكانت حياة المعتقل أشبه بتجربة علمية عملية، اختبر فيها نظريته، وتأكد له ما ذهب إليه.
عاصر فرويد الحرب العالمية الأولى وإرهاصات الثانية، ومع أنه قد نجا بنفسه وأسرته من النازية بالهجرة من النمسا، إلا أن نظرته للجنس البشري كانت نظرة قاتمة تشاؤمية، في حين خرج فرانكل من معتقلات النازية وهو أشد ما يكون تمسكًا بالإنسانية، وتفاؤلًا بقدرة الإنسان على التسامي بالأخلاق والقيم فوق كل الظروف، وإيجاد معنى في كل شيء حتى في المعاناة والبلاء، وقد يكون لهذه المفارقة تعلق بالإيمان، فبينا كان فرويد ملحدًا، يرى فراغ الوجود من معنى، والدين عنده محض وهم، كان فرانكل مؤمنًا بالله، يرى للوجود معنى وغاية، وفي الدين طريقًا للسمو بالروح.
يوضح فرانكل وجود معنىً في الأحوال المختلفة في الحياة، فقد يجده الإنسان من خلال العمل الخلاق، أو عند تذوق الجمال الراقي من ثقافة أو فن أو طبيعة خلابة، وقد يجد الإنسان المعنى في ذات شخص آخر، أي في الحب، بل وحتى في نوازل القدر من ابتلاء ومعاناة، فهناك معنى لو فطن الإنسان له وجعله نصب عينيه، لاستطاع تحمل المعاناة وتجاوزها في سبيله، بل وقد تصبح المعاناة سلمًا يرتقي بفكره وقيمه وروحه.
ومن باب الإنصاف نذكر أن لفرويد فضل في علم النفس لا يخفى، فهو بالرغم من أخطائه وشطحاته، إلا أنه قام بنقلة نوعية في علم النفس وأدخل فيه أبوابًا لم تكن معروفة من قبل، وطرح مسائل لم تكن تطرح سابقُا في هذا المجال، ولفت النظر إلى أمور كانت خافية على العلماء، وإن كان الخلاف قائما حول تفاصيل طرحه ونتائجه بل وبعض منطلقاته، إلا أن الكثير مما يعد بديهيات اليوم في علم النفس ما كان ليلتفت إليه قبلًا، بل حتى المآخذ التي عليه، فتحت بابًا للنظر والنقاش، وأدت إلى انبثاق نظريات أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لواتسون وسكينير وغيرهما، ممن تطرف وشطح في طرحه، فالكثير مما توصلوا إليه انتفع به الناس بعد أن أعيد النظر في تلك المسائل والأطروحات، وهذبت وروجعت وبني عليها غيرها، وهكذا تتطور العلوم.
فالحاصل أن العلم وإن شط لا يخلو عن فائدة إن تلقاه من يعقل ويحسن النظر.
،،وللحديث بقية
التعليقات
برجاء ذكر عنوان المقال عند التعليق
ebtihal.coach@gmail.com
© 2024. Coach Ebtihal Aljifri Lifestyle Development Consultancy. License No. CN-5315708. ADCCI No. 8800074026